مقدّمة
يعتبر التعليم من أهم المسائل التي تسعى إليها البشرية لزيادة المعرفة والحصول على مهارات تمكّن الأفراد داخل المجتمعات من العمل والإنتاج. كما يعتبر التعليم أداة مهمة في تحقيق التنمية على صعيد المجتمعات، الأمر الذي ينعكس على الأفراد داخل المجتمع بتطوير وتنمية القطاعات المختلفة؛ كالصحة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، ومعالجة قضايا المجتمع.
وضعت الأمم المتحدة "التعليم الجيد" كهدف رابع وأساسي ضمن أهداف التنمية المستدامة، وفي مضمون الهدف تقر الأمم المتحدة بأن "الهدف هو توفير فرص متساوية للحصول على التدريب المهني بأسعار معقولة، والقضاء على التمييز على أساس النوع الاجتماعي والثروة، وتحقيق الوصول الشامل إلى التعليم العالي الجيد".[1] والقضاء على التمييز يعني، بشكل أساسي، أيضاً، القضاء على التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وهو، أيضاً، ما وضعته الأمم المتحدة كهدف أساسي ضمن أهدافها للتنمية المستدامة؛ إذ جاء الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين"[2] كهدف أساسي للوصول لتنمية حقيقية على صعيد المجتمع، ويـأتي تحت مظلة هذا الهدف التعليم بلا شك (التعليم الإلزامي، والثانوي، والجامعي).
وعلى الرغم من أن التعليم، كقطاع، يجب أن يؤخذ به منذ التأسيس، والاهتمام به يجب أن يكون منذ المراحل الأولى لدى الفئات العمرية الصغيرة، فإن التعليم الجامعي يعبر، أيضاً، المرحلة الأساسية التي تؤهل الأفراد من مرحلة التعليم إلى المجتمع. إذ يعكس التعليم العالي أهدافاً مختلفة وفق الرؤى الوطنية، فهو يشكل أداة للتنمية المستدامة من خلال توسيع خيارات المجتمع، وإعداد كوادر بشرية قادرة على التفكير والتعبير، والفهم، والإنتاج العلمي، والنقدي.[3]
لذا، فإن الحياة الجامعية للطلبة، ذكوراً وإناثاً، تصقل فيها الأسس التي تبنى لاحقاً عليها الشخصية الذاتية للطلبة، كما ترسم فيها الملامح ذات العلاقة بالرؤى الوطنية وتحقيق التنمية على الصعيد المجتمعي لاحقاً. ومن ضمن هذا جميعه، تأتي المشاركة السياسية والأهلية والديمقراطية، التي تنعكس على المشاركة في القطاعات المختلفة كالاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
نفذت مؤسسة "مفتاح" هذه الدراسة المسحية لقياس مدى مشاركة الطالبات في الجامعات الفلسطينية في الحياة العامة (البعدان السياسي والخدمي كإطار)، وأخذت هذه الدراسة وهي الثانية من نوعها لـ"مفتاح" كلاً من جامعة النجاح في مدينة نابلس، وجامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، كمجتمع للدراسة للعام 2024، حيث كانت "مفتاح" قد نفذت الدراسة الأولى في العام الدراسي (2021/2022)، وكان مجتمع الدراسة في حينها الجامعة العربية الأمريكية في الضفة الغربية، وجامعة فلسطين في قطاع غزة.
مؤشرات وأرقام عامة
بخصوص التعليم العالي على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وبخصوص المؤشرات قبل حرب الإبادة الممارسة على الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، يشير الكتاب الإحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الأكاديمي 2022/2023، إلى أن عدد مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وصل إلى 51 مؤسسة، منها 19 جامعة تقليدية، وجامعة واحدة للتعليم المفتوح، و14 كلية جامعية، و17 كلية متوسطة. في حين توزعت هذه الأرقام ما بين 33 مؤسسة تعليم عالٍ في الضفة الغربية، و17 مؤسسة في قطاع غزة.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 132 مدرسة وجامعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بشكل كلي في قطاع غزة، و248 مدرسة وجامعة بشكل جزئي. كما أن حرب الإبادة أدت إلى استشهاد الآلاف من طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى استشهاد مئات المحاضرين الجامعيين وأساتذة المدارس. تسببت الحرب الحالية على قطاع غزة في حرمان أكثر من 88 ألف طالب جامعي من حقهم في استكمال تعليمهم، ما ترك تأثيرات كارثية على العملية التعليمية بشكل عام، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية الجامعات والمعلمين، وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا أكثر من 10,600 طفل، كما قُتل نحو 400 معلم في الحرب الإسرائيلية على القطاع حتى آب 2024، إضافة إلى إصابة أكثر من 15,300 طالب، و2,400 معلم، فضلاً عن نزوح مئات الآلاف من الشباب الذين اضطروا للعيش في خيم النزوح.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها الجامعات الفلسطينية بالقصف والتدمير الإسرائيلي، فخلال حرب العام 2008، قامت قوات الاحتلال بقصف الجامعة الإسلامية، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والمهنية، واستهدفت جامعة فلسطين، وجامعة القدس المفتوحة.
على مستوى الضفة الغربية، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الجامعات الفلسطينية بلا توقف. فمنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على الجامعات والطلاب في الضفة الغربية، حيث أودت بحياة ثلاثة عشر طالباً جامعياً، وتم اعتقال عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما اقتحمت قوات الاحتلال العديد من الجامعات الفلسطينية في المنطقة، وفرضت قيوداً صارمة على حياة المواطنين الفلسطينيين، ما جعل من الصعب على الطلاب الجامعيين الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا، ذكوراً وإناثاً، في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وصل إلى أكثر من 11,808، والذين أصيبوا 18,596، فيما استشهد في الضفة الغربية المحتلة 115 طالباً، وأصيب 603 آخرون، إضافة إلى اعتقال 450 من طلبة الجامعات والمدارس.
وإذا ما عدنا إلى البيانات حول الطلبة الجدد للعام الدراسي 2022/2023 قبل حرب الإبادة في الجامعات فقط (دون الكليات الجامعية، وكليات المجتمع المتوسطة)، لوجدنا أن المجموع العام للطلبة الجدد هو 50,390 طالباً/ة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 31,819 إناثاً (حوالي 63%). أما بخصوص الطلبة الملتحقين، فوصل العدد إلى 196,406 طلبة، منهم 125,049 طالبة (حوالي 64%). ووصل عدد الطلبة المتخرجين للسنة الدراسية 2021/2022 حوالي 40,106 خريجين وخريجات، منهم 26,061 إناثاً (حوالي 65%).
أهمية الدراسة
تعكس الأرقام المتعلقة بالطالبات الجامعيات حجم وثقل تواجد الطالبات في فضاء الجامعات، إذ يشكلن أكثر من 60% من هذا الفضاء عبر سنوات الدراسة. وفي النظر إلى الأمام، قد تصل النسبة لتشكل حوالي ثلثي مجتمع الجامعات من الطلاب. ترى "مفتاح" أنه لا بد من التركيز على تناول هذه الفئة ومشاركتها في الحياة العامة داخل الجامعة (البعد السياسي والإطار الخدمي)، وذلك لأن المشاركة السياسية للطالبات، كما مشاركتهن في الحياة العامة داخل الجامعات الفلسطينية، تُعدّ من بين أهم القضايا ذات الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية التي تؤثر، بشكلٍ كبيرٍ، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من هنا تنبع أهمية هذه الدراسة.
أهداف الدراسة
تسعى المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى تفعيل القيادات الشابة، وتمكينها من المشاركة في الحياتين العامة والسياسية، وذلك من خلال تعزيز بيئةٍ تفاعليةٍ وحواريةٍ داخل الجامعات تستند إلى مبادئ الديمقراطية والمساواة واحترام الحريات العامة، ومناهضة ممارسات التمييز والإقصاء والتهميش.
لذا، هدفت الدراسة إلى:
- التعرف على مَواطن التمييز، وإبراز الفجوات على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة للطلاب في الجامعات الفلسطينية.
- التوصل إلى توصيات ومقترحات علمية وعملية تستند إليها مراكز صنع القرار في الجامعات، للعمل على إصلاح سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها، بما يعزز من ترسيخ القيم الديمقراطية والتشاركية والإدماج ومناهضة الممارسات التمييزية ضد فئات الطلبة المختلفة داخل الجامعات.
- التوجه مستقبلاً للعمل مع الطلبة بالمجمل على زيادة الوعي تجاه قضايا المشاركة السياسية والعمل النقابي وتأهيلهم لذلك.
تعريفات ومفاهيم
- عدم التمييز فلسطينياً: نصت المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، على: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء لا تمييز بينهم بسبب العرق، أو الجنس، أو اللون، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الإعاقة". كما جاء في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية 1988 "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي، وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي، والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق، أو الدين، أو اللون، أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون، والقضاء المستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون".
- المساواة وعدم التمييز: عرفت اتفاقية "سيداو" التمييز بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق، أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
- المشاركة السياسية: هي عملية الانخراط في الصفوف الحزبية أو النقابية، وذلك بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في عملية صنع القرار داخل أروقة الصفوف الحزبية والنقابية؛ سواء على الصعيد السياسي العام، أو على صعيد السياسات الخدمية.
- المشاركة المدنية: مساهمة المواطنين في صنع القرار وفي إدارة شؤون البلاد، وذلك إما عبر التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بالمسار السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي، وإما عبر الانتخاب والتصويت، والعمل التطوعي، وحضور الندوات، والمشاركة في حملات الضغط والمناصرة. وهي بذلك تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مبادئ الديمقراطية، وإحدى أهم الأدوات لتحقيقها.
- الخصخصة (التعريف النظري): هي عملية تحويل كلي أو جزئي لرأسمال الشركات أو المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، عن طريق البيع المباشر أو غير المباشر، أو بواسطة السندات أو الأسواق المالية، ونقيضها هو التأميم.
- الخصخصة (التعريف الإجرائي): منح القطاع الخاص فرص الاستثمار وإدارة السلع والخدمات داخل الجامعة، ما يقلل من الرقابة على غلاء الأسعار، ويعزز من التمييز بين الطلاب على أساس الوضع الاقتصادي لكل طالب.
- الديمقراطية: تُعرف الديمقراطية بأنها نظام حكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكل مباشر أو من خلال اختيار مجموعة من الأشخاص لإدارة شأنهم العام، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، ويحتفظ النظام الديمقراطي بالسلطات الرئيسية "التشريعية والتنفيذية والقضائية" بشكل مستقل، وذات علاقة متوازنة.
- الدعاية الانتخابية: هي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحوها وممثلوها ومديرو الحملات الانتخابية ووكلاؤها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وهي كذلك الدعوات التي يتم توجيهها لجمهور الناخبين للتصويت لصالح قائمة معينة، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.
- المناظرة: حوار بين شخصين أو فريقين أو أكثر، يسعى كل منهما إلى الدفاع عن وجهة نظره بخصوص قضية عامة، وإثبات صحتها من عدمه، من خلال الوسائل العملية والمنطقية التي تعتمد على توفير الأدلة والبراهين محاولاً تفنيد وجهة نظر الطرف الآخر، وإثبات عدم صحتها.
- الحياة العامة في الجامعة (إجرائي): هي ممارسة كافة الأنشطة الموازية للحياة الأكاديمية؛ كالمشاركة في الانتخابات، والتمثيل النقابي في مجالس الطلبة، والأنشطة والمهرجانات، والمناظرات والندوات.
منهجية الدراسة
يمكن القول إن الدراسة اعتمدت على مناهج مختلطة، حيث تعتمد الدراسة، بشكل أساسي، المنهج المسحي الوصفي لعرض مخرجات المسح، والمنهج الوصفي التفسيري الذي من خلاله يتم قياس أثر المتغيرات على بعضها البعض، إضافة إلى المنهج المقارن داخل مجتمع الدراسة مع السنوات السابقة في مجتمعات أخرى للدراسة. وبخصوص أداة جمع المعلومات، فهي أداة كمية عكست النتائج كمؤشرات ونسب، واعتمدت استمارة مسحية وزعت في الجامعات المستهدفة، إذ قامت "مفتاح" بتدريب ما يقارب 41 طالباً/ة (26 من الإناث، و15 من الذكور)، قاموا بجمع البيانات عبر استمارة تم تفريغها إلكترونياً على أجهزة لوحية محمولة.
تقيس الاستمارة مجموعة من المؤشرات التي يمكن وصفها كالآتي: المؤشر الأول يتعلق بوصف المبحوثين (الجنس، مكان السكن، المحافظة، الحالة الاجتماعية، حالة التعليم ما بين عادي وموازٍ، حالات الإعاقة إن وجدت). المؤشر الثاني يتعلق بالموقف من مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة (مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجانات، المناظرات والندوات...). أما المؤشر الثالث، فيقيس الموقف من انخراط الطالبات في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية. والمؤشر الرابع يقيس الموقف من تأييد لمشاركة الطالبات في الحياة العامة، أما المؤشر الخامس والأخير فيقيس الموقف من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالطالبات (يرجى الاطلاع على الملحق رقم 1). استخدم الباحث الجداول الإحصائية للنسب المئوية، بعد استخراج التكرارات. وتم التعبير عن المؤشرات بمتغيرات فئوية (أوافق، محايد، لا أوافق، لا أعرف).
بخصوص مجتمع الدراسة، يعتبر مجتمع الدراسة هو مجتمع جامعتي النجاح في مدينة نابلس وبوليتكنيك فلسطين في مدينة الخليل للعام 2024. وشملت الدراسة 277 مبحوثاً/ة في جامعة النجاح (135 ذكور و142 إناث)، في حين كانت في جامعة بوليتكنيك فلسطين 231 مبحوثاً/ة (116 ذكور، و115 إناث)، ما يعني أن عينة الدراسة وصلت حوالي 508 مبحوثين/ات في كلتا الجامعتين.
نتائج الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على الأداة الكمية في جمع البيانات كما ذكرنا، وذلك لقياس مَواطن التمييز، وإبراز الفجوات على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة للطلبة في الجامعات الفلسطينية، وبخاصة الإناث منهم، التي تحد من مشاركتهن في الحياتين العامة والسياسية داخل الجامعات الفلسطينية. وقبل عرض النتائج الخاصة بالدراسة، نقدم وصفاً تفصيلياً لعينة الدراسة لكل جامعة على حدة.
وصف المبحوثين/ات في جامعة النجاح
ضمن إطار عينة الدراسة، جاء من مجمل 508 مبحوثين/ات 277 مبحوثاً/ة في جامعة النجاح، 135 ذكور و142 إناث؛ أي بنسبة 48.7% ذكور، و51.3% إناث من العينة في جامعة النجاح. ويشكل/تشكل هؤلاء حوالي 54.5% من إجمالي العينة الكلية. وعند سؤال المبحوثين/ات عن مكان سكنهم/ن، عبَّر 54.9% أنهم/ن من سكان المدينة، وحوالي 32.8% هم/ن من سكان الريف، وحوالي 12.27% يقطنون في مخيمات. وأعرب 6.1% من المبحوثين/ات عن أنهم/ن من الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يلتحق ما يقارب 23.5% من المبحوثين/ات في الجامعة بالنظام الموازي، و76.5% بالنظام العادي.
من المهم الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي أشارت في الكتاب الإحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2022/2023، إلى أن عدد الطلبة المسجلين في جامعة النجاح كان قد وصل للعام الأكاديمي 2022/2023 حوالي 24,231 طالباً/ة، منهم 66.3% إناثاً.
وصف المبحوثين/ات في جامعة بوليتكنيك فلسطين
من مجمل 508 مبحوثين/ات بلغ عدد المبحوثين/ات في جامعة بوليتكنيك فلسطين 231 مبحوثاً/ة، 116 ذكور، و115 إناث؛ أي بنسبة 50.2% ذكور، و49.8% إناث من العينة في جامعة بوليتكنيك فلسطين. ويشكل/تشكل هؤلاء حوالي 45.8% من إجمالي العينة الكلية. وعند سؤال المبحوثين/ات عن مكان سكنهم، عبر 59.3% أنهم/ن من سكان المدينة، وحوالي 35% هم/ن من سكان الريف، وحوالي 5.6% فقط يقطنون في مخيمات. وأعرب 4.3% من المبحوثين/ات أنهم/ن من الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يلتحق ما يقارب 6.5% من المبحوثين/ات في الجامعة بالنظام الموازي، و93.5% بالنظام العادي.
أشارت وزارة التربية والتعليم العالي في الكتاب الإحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2022/2023 إلى أن عدد الطلبة المسجلين في جامعة بوليتكنيك فلسطين كان قد وصل للعام الأكاديمي 2022/2023 حوالي 5,637 طالباً/ة، منهم حوالي 57% إناثاً.
المحور الأول: مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة
تناولت الدراسة في قياس الموقف من مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة مجموعة من المؤشرات التي تعكس أبرز المؤشرات ذات الدلالة الإحصائية، والتي تشير إلى أشكال التمييز. ومن هذه المؤشرات السؤال حول المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة، والسؤال حول ما إذا كانت مشاركة الطالبات في الحياة العامة تساهم في توفير بيئة أفضل للطلاب والطالبات من حيث الوصول والحصول على الخدمات، والسؤال حول ما إذا كان/ت المبحوثون/ات يرون أن مشاركة الطالبات في الحياة العامة تأتي بناءً على الانتماء الحزبي، والسؤال حول ما إذا كانت مشاركة الطالبات في الحياة العامة تستند إلى الثقافة المجتمعية ذات المرجعية العائلية والعشائرية، وما إذا كانت مشاركة الطالبات في الحياة العامة تنبع من الشخصية القيادية والوعي الثقافي لدى الطالبات في الجامعة، والسؤال ما إذا كانت مشاركة الطالبات في الحياة العامة تعتمد على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية الدينية.
هذا المحور يركز في جله على مجتمع الجامعة، وإذا ما كان يتيح للمرأة المشاركة والانخراط في العمل النقابي على صعيد الجامعة، ويقيس الموقف من العوامل المختلفة التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة أم تؤثر عليها بالسلب.
|
المحور: مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة |
||
|
الجامعة |
الموقف/المؤشر |
|
|
بوليتكنيك فلسطين |
النجاح |
|
|
عند سؤال المبحوثين/ات في جامعة بوليتكنيك فلسطين حول المؤشر نفسه، نلاحظ أن نسبة من عبروا/ن عن الموافقة بأن الجامعة توفر المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة، أجاب 43.3% فقط بالموافقة (50% من الذكور، و37% من الإناث)، وعبر/ت 24.24% أنهم/ن على حياد من الإجابة عن هذا السؤال (21% من الذكور، و28% من الإناث)، في حين قال/ت 28.6% إنهم/ن لا يوافقون على إيجابية المؤشر (21% من الذكور و28% من الإناث). |
أجاب ما يقارب 57.4% أنهم/ن يوافقون على أن الجامعة توفر المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة (60% منهم ذكور و55% إناث)، في حين أجاب ما يقارب 23% أن الجامعة لا توفر ذلك (21% ممن عبروا لذلك من الذكور، و25% من الإناث). |
تتوفر في الجامعة المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة. |
| كانت النسبة في التعبير عن تأييد العبارة في المؤشر أقل، حيث كانت 63.2% (59% من الذكور، و68% من الإناث)، في حين حوالي 20% فضلوا/فضلن الحياد (19% من الذكور، و21% من الإناث) و14% لا يوافقون العبارة في المؤشر، ويرون أن ذلك لا يساهم في توفير بيئة أفضل للطلاب والطالبات (19% من الذكور، و9% من الإناث). | عبّر 69.3% من المبحوثين/ات أنهم/ن يؤيدون ذلك (64% من الذكور، و74% من الإناث)، في حين عبر نحو 14% بأنهم/ن يتخذون الحياد في التعبير حول هذه المسألة (17% من الذكور، و12% من الإناث) وبالنسبة ذاتها لمن لا يؤيدون العبارة الواردة في المؤشر (16% من الذكور، و13% من الإناث). | تساهم مشاركة الطالبات في الحياة العامة في توفير بيئة أفضل للطلاب والطالبات من حيث الوصول والحصول على الخدمات من وجهة نظر المبحوثين. |
| عبر/ت 56.7% من المبحوثين/ات بأنهم/ن يؤيدون العبارة في المؤشر (52% من الذكور، و62% من الإناث)، في حين عبر حوالي 22.5% من إجمالي المبحوثين/ات في البوليتكنك بالحياد تجاه هذه العبارة (22% من الذكور، و23% من الإناث)، وحوالي 17% لا يؤيدون العبارة (19% من الذكور، و9% من الإناث). | أجاب/ت 64.26% في جامعة النجاح أنهم يؤيدون العبارة في المؤشر (61% من الذكور، و67% من الإناث)، في حين عبر/ت حوالي 17% (17% من الذكور، و18% من الإناث) من إجمالي المبحوثين/ات في جامعة النجاح بالحياد تجاه العبارة في المؤشر، وحوالي 15.5% لا يؤيدون هذا الطرح (19% من الذكور، و12% من الإناث). | مشاركة الطالبات في الحياة العامة في توفير بيئة ديمقراطية لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة. |
| على صعيد جامعة بوليتكنيك فلسطين، تقترب النسب في التعبير عن ذلك، حيث عبر/ت 30.3% فقط من المبحوثين/ات بأنهم/ن يوافقون على العبارة، في حين 37.6% لا يؤيدون العبارة في هذا المؤشر، ويرون أن المشاركة لا تأتي بناءً على الانتماء الحزبي، دون وجود اختلافات تذكر على صعيد متغير الجنس. | من الملفت أن طلبة جامعة النجاح يؤيدون هذه العبارة فقط بنسبة 27% (31% من الذكور، و24% من الإناث)، في حين عبر/ت 42.6% منهم/ن أنهم/ن لا يؤيدون هذه العبارة في المؤشر (39% من الذكور، و46% من الإناث). | مشاركة الطالبات في الحياة العامة في المجمل تأتي بناءً على الانتماء الحزبي. |
| عبر/ت أكثر من نصف المبحوثين/ات بنسبة 58% أنهم/ن يوافقون على هذه العبارة، في حين يرى/ترى 20.7% أنهم لا يتفقون مع العبارة في المؤشر (16% من الذكور، و26% من الإناث). | عبر/ت حوالي 35% من المبحوثين/ات أنهم/ن يؤيدون هذه العبارة في المؤشر، دون وجود دلالة إحصائية بناءً على متغير الجنس، في حين عبر/ت 32% أنهم/ن لا يوافقون على هذه العبارة (36% من الذكور، و28% من الإناث). | مشاركة الطالبات في الحياة العامة في المجمل تعتمد على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية العائلية والعشائرية. |
| في جامعة بوليتكنك فلسطين، عبر/ات حوالي 77.5% من المبحوثين/ات أنهم/ن يتفقون مع هذه العبارة، مع وجود علاقة ذات دلالة إحصائية (73% من الذكور، و82% من الإناث)، وحوالي 7% فقط لا يتفقون مع العبارة. | عبر/ت 80% من المبحوثين/ات في جامعة النجاح أنهم يتفقون مع هذه العبارة في المؤشر دون وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس، في حين عبر/ت 6% فقط بأنهم/ن لا يوافقون على العبارة ودون وجود علاقة ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس حول العبارة. | مشاركة الطالبات في الحياة العامة تعتمد على الشخصية القيادية والوعي الثقافي. |
| على صعيد جامعة بوليتكنيك فلسطين، يتفق 59.7% من المبحوثين/ات مع هذه العبارة، في حين 15% فقط يرون أن لا علاقة بالمرجعية الدينية للمشاركة في الحياة العامة، و19% عبروا/ن بالحياد، دون وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بناءً على متغير الجنس في النسبتين الأخيرتين. | في جامعة النجاح، أجاب/ت 40.4% من المبحوثين/ات أنهم/ن يوافقون على هذه العبارة في المؤشر، في حين عبر/ت ما يقارب 28% منهم/ن أنهم/ن لا يتفقون مع هذه العبارة. | تعتمد مشاركة الطالبات في الحياة العامة على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية الدينية. |
المحور الثاني: من مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية
على صعيد قياس الموقف من مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية، وحياة النماذج التمثيلية للانخراط في الحياة العامة، بمعنى ممارسة الأنشطة الموازية للحياة الأكاديمية كافة، تناولت الدراسة مجموعة من المؤشرات تحت هذا المحور. تقيس هذه المؤشرات ما إذا كان هنالك شكل من أشكال التمييز المبني على متغير الجنس. ومن هذه المؤشرات السؤال حول ما إذا كانت تتوفر في الجامعة بيئة ديمقراطية داعمة لمشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة، والسؤال حول ما إذا كانت مشاركة الطالبات تؤثر في انتخابات مجالس الطلبة على نسب التصويت للقوائم الانتخابية، وما إذا كانت المشاركة في انتخابات مجالس الطلبة من قبل الطالبات تعتمد على الانتماء الحزبي للطالبة، وقياس الموقف حول ما إذا كان الخطاب العام في مجتمع الجامعة داعماً لمشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية، والموقف حول ما إذا كانت الثقافة المجتمعية داخل الجامعة تميز ضد مشاركة الطالبات في داخل مجالس الطلبة والأندية الطلابية، إضافة إلى التوجه حول الموقف الطلابي السائد في الجامعة ما إذا كان لا يثق بقدرة الطالبات على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية، والموقف من العبارة القائلة إن محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات تعود إلى ضعف الشخصية لدى الطالبات، والعبارة القائلة إن محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات تعود إلى عدم اهتمامهن بالشأن العام، إضافة إلى ما إذا كان تصنيف مكان السكن (مدينة، قرية، مخيم، تجمع بدوي ...) يشكل عاملاً تمييزياً ضد الطالبات في المشاركة في الحياة السياسية داخل الجامعة. وأخيراً الموقف مما إذا كان وصول الطالبات إلى مراكز قيادية داخل المجالس والأندية الطلابية يعود إلى قوة شخصية الطالبات والمهارات القيادية لديهن.
يختلف هذا المحور عن المحور السابق في أنه يجمع مجموعة من المؤشرات التي تعكس المواقف المختلفة حول الأنشطة في الحياة العامة والمشاركة فيها، إضافة إلى الموقف حول مشاركة الطالبات وما إذا كان لها أثر على النتائج العامة للانتخابات والدوافع وراء مشاركتهم/ن.
|
المحور: مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية |
||
|
الجامعة |
الموقف/المؤشر |
|
|
بوليتكنيك فلسطين |
النجاح |
|
|
حوالي 39% من العينة ترى أنه تتوفر في الجامعة بيئة ديمقراطية داعمة لمشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة (48% من الذكور، و30% من الإناث). في حين أن أكثر من ربع العينة (26.4%) لا يرون ذلك دون وجود دلالة ذات علاقة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. في حين عبر/ت 19.5% من المبحوثين/ات أنهم/ن يفضّلون الحياد في اتخاذ موقف من هذه العبارة (12% من الذكور، و27% من الإناث). |
حوالي نصف العينة في جامعة النجاح (50.5%) من الطلاب والطالبات ترى أن الجامعة توفر المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة (56% من الذكور، و46% من الإناث)، في حين يرى 24% من الطلبة والطالبات أنهم/ن لا يتفقون مع هذه العبارة، دون وجود أي دلالة ذات علاقة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. في حين عبر/ت 16.6% منهم/ن أنهم على حياد من التعبير حول هذه المسألة. |
تتوفر في الجامعة بيئة ديمقراطية داعمة لمشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة. |
| أجاب/ت حوالي 72% من المبحوثين/ات أنهم/ن يرون أن مشاركة الطالبات تؤثر في نتائج انتخابات مجالس الطلبة فعلاً (79% من الذكور، و64% من الإناث)، في حين يرى/ترى 5.5% فقط أنها لا تؤثر. | عند سؤال المبحوثين/ات حول موقفهم من مشاركة الطالبات في انتخابات مجلس الطلبة، وما إذا كانت تؤثر على نسب التصويت للقوائم، أفاد/ت 69% من المبحوثين/ات بأنهم يرون أن مشاركة الطالبات فعلاً توثر في نتيجة الانتخابات (75% من الذكور، و63% إناث)، في حين يرى فقط حوالي 11% أنها لا تؤثر. | مشاركة الطالبات تؤثر في انتخابات مجالس الطلبة على نسب التصويت للقوائم الانتخابية. |
| يرى/ترى حوالي 55% من المبحوثين/ات أن المشاركة في مجالس الطلبة من قبل الطالبات تعتمد على الانتماء الحزبي للطالبة (للطالبة التي تقوم بالتصويت)، بوجود فرق ذي دلالة إحصائية (60% من الذكور، و50% من الإناث). في حين عبر/ت 16% فقط أنهم/ن لا يرون لذلك علاقة في المشاركة. | عبر/ت 48.7% من المبحوثين/ات أن المشاركة في انتخابات مجالس الطلبة من قبل الطالبات تعتمد على الانتماء الحزبي للطالبة (للطالبة التي تقوم بالتصويت)، دون وجود فروقات ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. أما بخصوص الموقف بعدم الموافقة، فقد أفاد ما نسبته 26% بأنهم/ن لا يعتقدون ذلك، دون وجود فروقات ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. | المشاركة في انتخابات مجالس الطلبة من قبل الطالبات تعتمد على الانتماء الحزبي للطالبة. |
| عبر/ت 42.42% من المبحوثين/ات أن الخطاب العام في مجتمع الجامعة يدعم مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية (48% من الذكور، و37% من الإناث). في حين يرى/ترى 22% من المبحوثين/ات أن مجتمع الجامعة ليس بداعم (16% من الذكور، و28% من الإناث)، وحوالي 22.5% من المبحوثين/ات أفادوا برغبتهم/ن في التعبير بالحياد تجاه اتخاذ موقف من هذه العبارة. | عند سؤال المبحوثين/ات حول الموقف من الخطاب العام في مجتمع الجامعة، وما إذا كان داعماً لمشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية، عبر/ت ما يقارب 40% من المبحوثين/ات أن الخطاب العام داعم لذلك، دون وجود فروقات ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. في حين أفاد/ت ما نسبته 24.5% أن الخطاب العام غير داعم لذلك، دون فروق ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. وحوالي ربع المبحوثين/ات أفادوا بأنهم يتخذون الحياد في أخذ موقف من هذه العبارة. | الخطاب العام في مجتمع الجامعة داعم لمشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية. |
| حوالي 30% من المبحوثين/ات أفادوا بأنهم يتفقون مع العبارة التي تقول إن الثقافة المجتمعية داخل الجامعة تميز ضد مشاركة الطالبات في داخل مجالس الطلبة والأندية (26% من الذكور، و34% من الإناث). في حين أفاد/ت 37% منهم/ن بأنهم/ن لا يتفقون مع العبارة (44% من الذكور، و30% من الإناث). | حوالي 29% من المبحوثين/ات يوافقون على أن الثقافة المجتمعية داخل الجامعة تعمل على التمييز ضد مشاركة الطالبات في داخل مجالس الطلبة والأندية الطلابية (33% من الذكور، و25% من الإناث). وحوالي 38% لا يتفقون مع هذه العبارة من حيث الموقف، دون وجود أي علاقة ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. لكن من الملفت للانتباه أنه وفيما يتعلق بالطلبة والطالبات الذين اتخذوا الحياد تجاه هذه العبارة، والذين وصلت نسبتهم حوالي 24%، نلاحظ أن من هؤلاء هم 19% من الذكور/ و30% من الإناث، وهو فرق ذو دلالة إحصائية لا بد من الإشارة إليه. | الثقافة المجتمعية داخل الجامعة تميز ضد مشاركة الطالبات في داخل مجالس الطلبة والأندية الطلابية. |
| 40.7% من المبحوثين/ات أفادوا بالموافقة على أن الموقف الطلابي السائد في الجامعة لا يثق بقدرة الطالبات على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية، دون وجود أي اختلاف ذي دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. في حين أن 31.6% لا يتفقون مع العبارة بأن الموقف الطلابي السائد في الجامعة لا يثق بالطالبات على المشاركة في هذه الأنشطة (37% من الذكور، و26% من الإناث). | حوالي 45.5% من المبحوثين/ات أفادوا بأن الموقف الطلابي السائد في الجامعة لا يثق بقدرة الطالبات على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية (40% من الذكور، و51% من الإناث). في حين عبر/ت حوالي 30% من المبحوثين/ات أنهم/ن لا يرون أن هنالك عدم ثقة بقدرة الطالبات على المشاركة في هذه الأنشطة. | الموقف الطلابي السائد في الجامعة ما إذا كان لا يثق بقدرة الطالبات على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية. |
| وبينما كانت النسبة في جامعة النجاح حوالي 25%، كانت النسبة تجاه هذه العبارة بالموافقة في جامعة بوليتكنيك فلسطين بحوالي 34% (40% من الذكور، و29% من الإناث). ويرى حوالي 48.48% من المبحوثين/ات أنهم/ان لا يتفقون مع هذا الطرح. | حوالي 25% من المبحوثين/ات أفادوا بأن ضعف الشخصية لدى الطالبات هو ما يدفعهن إلى عدم استلام مناصب قيادية داخل مجالس الطلبة وأندية الكليات (29% من الذكور، و21% من الإناث). في حين عبر/ت حوالي 52% من المبحوثين/ات بأنهم/ن لا يتفقون مع هذا الطرح (47% من الذكور، و57% من الإناث). ويرى/ترى 16% أنهم/ن يفضلون اتخاذ الحياد تجاه هذه العبارة. | محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات، تعود إلى ضعف الشخصية لدى الطالبات. |
| أفاد حوالي 40% من المبحوثين/ات بأنهم يتفقون مع العبارة التي تقول إن محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات يعود إلى عدم اهتمام الطالبات بالشأن العام (47% من الذكور، و34% من الإناث). في حين عبر/ات 31.6% أنهم/ن لا يتفقون مع العبارة، (28% من الذكور، و36% من الإناث). |
عند السؤال ما إذا كان السبب في محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية وما إذا كان ناجماً عن عدم اهتمامهن بالشأن العام، أفاد حوالي 36.8% من المبحوثين/ات بأن موقفهم/ن بالموافقة على هذه العبارة (41% من الذكور، و33% من الإناث). و31% أفادوا بأنهم/ن لا يتفقون مع هذه العبارة (27% من الذكور، و35% من الإناث). في حين قرر 22% التحفظ والتعبير بالحياد تجاه هذه العبارة. |
محدودية عدد الطالبات في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات، تعود إلى عدم اهتمامهن بالشأن العام. |
| تقريباً تساوت النسبة ما بين موافق لهذه العبارة وما بين رافض لها في جامعة بوليتكنيك فلسطين، حيث أشار 37.7% من الطلبة والطالبات إلى أنهم يتفقون مع هذه العبارة (43% من الذكور، و32% من الإناث). في حين أن حوالي 39% من المبحوثين/ات لا يتفقون مع هذا الطرح، و17.3% فضلوا أن يتخذوا الحياد تجاه هذه العبارة. |
33.5% من المبحوثين/ات يرون أن مكان السكن (مدينة، قرية، مخيم ... إلخ) يشكل عاملاً تمييزياً ضد الطالبات في المشاركة في الحياة السياسية داخل الجامعة، دون وجود علاقة ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. في حين يرى/ترى 40% أن لا علاقة لذلك، ولا يشكل مكان السكن عاملاً تمييزياً. في حين فضَّل 18.7% الحياد في الإجابة حول هذه العبارة وأخذ موقف منها. |
تصنيف مكان السكن (مدينة، قرية، مخيم، تجمع بدوي ...) يشكل عاملاً تمييزياً ضد الطالبات في المشاركة في الحياة السياسية داخل الجامعة. |
| كما هو الحال في جامعة النجاح، يرى 75% من الطلبة والطالبات في جامعة بوليتكنيك فلسطين أنهم يتفقون مع هذه العبارة ويوافقون عليها، في حين عبر/ت 10.4% أنهم لا يتفقون مع هذه العبارة. ولا يوجد أي فرق ذي دلالة إحصائية بناءً على متغير الجنس لكلا الموقفين. |
عند السؤال حول ما إذا كان وصول الطالبات إلى مراكز قيادية داخل مجالس الطلبة والأندية يعود إلى قوة الشخصية للطالبات، أفاد 76% من المبحوثين/ات بالموافقة على هذه العبارة. بينما يرى 10.5% فقط أنهم/ن لا يتفقون مع هذا الطرح. ولا يوجد أي فرق ذي دلالة إحصائية بناءً على متغير الجنس لكلا الموقفين. |
وصول الطالبات إلى مراكز قيادية داخل المجالس والأندية الطلابية يعود إلى قوة الشخصية للطالبات والمهارات القيادية لهن. |
المحور الثالث: تأييد الطلبة والطالبات لمشاركة النساء في الحياة العامة
يتناول هذا المحور مجموعة من المؤشرات التي تقيس الموقف حول تأييد مشاركة الطالبات في الحياة العامة (الأنشطة الموازية للحياة الأكاديمية؛ كالمشاركة في الانتخابات، والتمثيل النقابي في مجالس الطلبة، والأنشطة والمهرجانات، والمناظرات والندوات). ويختلف هذا المحور عن المحاور السابقة من حيث إنه يعكس ما هي التوجهات لدى الطلبة للتغير من واقع التمييز داخل الجامعات إن وجد. من أبرز المؤشرات التي تأتي تحت هذا المحور الموقف من رفع نسبة مشاركة الطالبات في الحياة العامة في الجامعة، والسؤال حول ما إذا كان الطالب/ة يقدم الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة ضمن المحيط الخاص (العائلة والأصدقاء)، وإذا ما كان الطالب/ة يقدم الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة ضمن المحيط العام (مجلس الطلبة، أندية الكليات، أنشطة طلابية ثقافية ورياضية)، والسؤال حول ما إذا كانت القناعة الشخصية لدى المبحوثين/ات هي الدافع وراء دعم الطالبات للمشاركة، أو كان الدافع هو المرجعيات العائلية أو العشائرية، أو حتى المرجعية الحزبية، أو مرجعية دينية. والموقف من أن التأييد يأتي بناءً على قدرة الطالبات في التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن إطار الجامعة التي تؤثر بشكل مباشر على طلاب الجامعة وطالباتها. وحول ما إذا ما كان تأييد المبحوثين/ات للطالبات يأتي بناءً على قدرة الطالبات في التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن إطار الجامعة التي تؤثر بشكل مباشر على طلاب الجامعة وطالباتها.
|
المحور: التأييد لمشاركة المرأة في الحياة العامة |
||
|
الجامعة |
الموقف/المؤشر |
|
|
بوليتكنيك فلسطين |
النجاح |
|
|
حوالي 68% من الطلبة والطالبات يؤيدون رفع نسبة مشاركة الطالبات في الحياة العامة في الجامعة (58% من الذكور، و78% من الإناث). في حين يرى حوالي 13.4% من المبحوثين/ات أنهم لا يؤيدون رفع نسبة المشاركة (22% من الذكور، و5% من الإناث)، في حين أجاب/ت 18% أنهم/ن يفضلون الالتزام بالحياد تجاه هذا المؤشر كموقف. |
حوالي 80% من الطلبة والطالبات عبروا/ن عن أنهم مع رفع نسبة مشاركة الطالبات في الحياة العامة في الجامعة (67% من الذكور، و92% من الإناث). في حين يرى/ترى 12% من العينة أنهم/ن لا يتفقون مع رفع نسبة مشاركة الطالبات في الحياة العامة في الجامعة، ومن الجدير بالذكر أن من بين هؤلاء 20% من الذكور، و4%، فقط، من الإناث. | رفع نسبة مشاركة الطالبات في الحياة العامة في الجامعة. |
| 73% من الطلبة والطالبات أفادوا بالموافقة على أنهم يقدمون الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة ضمن حيزهم/ن الخاص (64% من الذكور، و83% من الإناث). في حين عبر/ت 14.3% أنهم/ن لا يؤيدون ذلك (21% من الذكور، و8% من الإناث). |
78.7% من الطلبة والطالبات يقدمون الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة ضمن حيزهم/ن الخاص (70% من الذكور، و87% من الإناث). في حين عبر/ت حوالي 12% أنهم يتخذون الحياد من هذا المؤشر كموقف. |
أقدم الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة ضمن المحيط الخاص (العائلة والأصدقاء). |
| 65.4% من المبحوثين/ات أجابوا بالموافقة على أنهم/ن يقدمون الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة في المحيط العام في جامعة بوليتكنيك فلسطين. في حين أشار/ت حوالي 14.3% منهم/ن إلى أنهم لا يوافقون (20% من الذكور، و9% من الإناث). و17% فضلوا الحياد تجاه أخذ موقف حول هذه العبارة. |
كانت النسبة أقل في التأييد حول الموقف من تقديم الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة في المحيط العام منها في الحيز الخاص، إذ وصلت النسبة حوالي 71.5% (65% من الذكور، و77% من الإناث). في حين كانت نسبة من لا يوافقون هي 11.5% (15% من الذكور، و8% من الإناث). وعبر/ت المبحوثون/ات بنسبة 17% أنهم/ن يفضلون الحياد تجاه أخذ موقف من هذه العبارة. |
أقدم الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة في المحيط العام (مجالس الطلبة، أندية الكليات، أنشطة طلابية ثقافية ورياضية). |
| عند سؤال المبحوثين/ات في جامعة بوليتكنيك فلسطين حول هذا المؤشر، أجاب/ت 75.75% أنهم/ن يؤيدون العبارة بأن التأييد للطالبات للمشاركة في الحياة العامة يأتي بناء على قناعات شخصية للمبحوثين/ات. |
حوالي 69.6% من المبحوثين/ات يؤيدون العبارة بأن التأييد للطالبات للمشاركة في الحياة العامة يأتي بناء على قناعات شخصية للمبحوثين/ات، دون وجود أي علاقة ذات دلالة إحصائية تذكر وفقاً لمتغير الجنس. وحوالي 8.7%، فقط، يرون أن هذا غير صحيح، وأنهم غير مقتنعين بذلك. |
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة على قناعاتي الشخصية. |
| أما في جامعة بوليتكنيك فلسطين، فقد أفاد 43% بأنهم/ن يرون أن ذلك فعلاً يؤثر على تأييد الطالبات للمشاركة في الحياة العامة. في حين يرى/ترى حوالي 36% من المبحوثين/ات أن لا علاقة لذلك بتأييدهم/ن. |
بخصوص السؤال حول المرجعيات العائلية أو العشائرية، وما إذا كانت تؤثر على تأييد المبحوثين/ات للطالبات للمشاركة في الحياة العامة، أفاد 24% بأنهم/ن يرون أن ذلك يؤثر على التأييد. في حين يرى/ترى حوالي 45% من المبحوثين/ات أن لا علاقة لذلك بتأييدهم/ن. |
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي العائلية أو العشائرية. |
| بخصوص جامعة بوليتكنيك فلسطين، عبر/ت 56% أنهم/ن لا يرون أن تأييدهم/ن للطالبات للمشاركة في الحياة العامة يأتي بناءً على مرجعيتهم/ن الحزبية. واقتربت النسبة في جامعة النجاح فيمن يرون ذلك، إذ بلغت حوالي 19.5%. |
على صعيد جامعة النجاح، حوالي 49% من المبحوثين/ات لا يرون أن تأييدهم/ن للطالبات للمشاركة في الحياة العامة يأتي بناءً على مرجعيتهم/ن الحزبية. فقط 19% منهم/ن يرون ذلك. |
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي الحزبية. |
| 65.4% من الطلبة والطالبات يرون أن تأييدهم/ن للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة يأتي وفقاً لقدرة الطالبات في التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن إطار الجامعة التي تؤثر بشكل مباشر على طلاب الجامعة وطالباتها. في حين 7%، فقط، لا يوافقون على أن هذا هو سبب التأييد. |
61.4% من الطلبة والطالبات يرون أن تأييدهم/ن للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة يأتي وفقاً لقدرة الطالبات في التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن إطار الجامعة التي تؤثر، بشكل مباشر، على طلاب الجامعة وطالباتها. في حين 10.5%، فقط، لا يوافقون على أن هذا هو سبب التأييد. |
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة وفقاً لقدرة الطالبات في التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن إطار الجامعة التي تؤثر بشكل مباشر على طلاب الجامعة وطالباتها. |
|
كانت النسبة أعلى بكثير في جامعة بوليتكنيك فلسطين حول التأييد من العبارة القائلة بأن "يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي الدينية"، إذ وصلت النسبة حوالي 65.4%. في حين وصلت نسبة من لا يوافقون مع هذا الطرح حوالي 7% فقط. |
عند سؤال المبحوثين/ات حول ما إذا كانت المرجعية الدينية هي الأساس في التأييد للطالبات للمشاركة في الحياة العامة، أجاب/ت حوالي 42.6% من المبحوثين/ات أنهم يتفقون مع هذه العبارة كموقف. في حين عبر/ت 32.5% لا يرون أن هذا هو الأساس في التوجه نحو التأييد. |
يعتمد تأييدي للطالبات للمشاركة في الحياة العامة في الجامعة على مرجعياتي الدينية. |
المحور الرابع: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يأتي هذا المحور ليقيس أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الجامعة على الفرص المتاحة للطلبة والطالبات فيما يتعلق بالصحة، والمباني الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحول ما إذا كانت تكلفة الساعة الدراسية تؤثر على خيارات الطلاب والطالبات التعليمية، إضافة إلى الموقف من سياسة خصخصة السلع والخدمات داخل الجامعة، وما إذا كان فيها تمييز ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود. كذلك الموقف حول ما إذا كانت هنالك ممارسات تمييزية ضد الطالبات في تلقي الخدمات التعليمية (ابتزاز، تحرش، اعتداء......)، وإذا ما كان لدى الطالبات القدرة في الحصول على المنح والتغطية المالية داخل الجامعة، وبخاصة الطالبات من الفئات ذات الدخل المحدود. والمؤشر الأخير الذي يقيس ما إذا كانت تحرم بعض الطالبات في الجامعة من الوصول إلى المرافق التعليمية نظراً لعدم توفر القدرة المادية للوصول إلى الجامعة من وجهة نظر المبحوثين/ات.
|
المحور: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
||
|
الجامعة |
الموقف/المؤشر |
|
|
بوليتكنيك فلسطين |
النجاح |
|
| حوالي 31% من الطلبة والطالبات يرون أن الجامعة تقوم بتوفير خدمات صحية مناسبة موائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات، وكان هنالك فرق ذو دلالة إحصائية (36% من الذكور، و26% من الإناث). في حين عبر/ت حوالي 48.5% من المبحوثين/ات أنهم/ن يرون أن الجامعة لا توفر هذه الخدمات، دون وجود دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. |
عبّر فقط 40% من عينة طلبة جامعة النجاح أن الجامعة تقوم بتوفير خدمات صحية مناسبة موائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات، وتساوت النسبة تقريباً مع الذين يرون أن الجامعة تقوم بتوفير ذلك. | توفر الجامعة خدمات صحية مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات. |
| ثلث المبحوثين/ات عبروا أن بنايات ومرافق الجامعة مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات. في حين عبر حوالي 45.5% من أن بنايات ومرافق الجامعة ليست مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات. |
42%، فقط، من العينة ترى أن بنايات ومرافق الجامعة مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات. في حين عبر/ت حوالي 34% أنها ليست مناسبة وموائمة. |
بنايات ومرافق الجامعة مناسبة وموائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات. |
| 85% من المبحوثين/ات يرون أن لتكلفة الساعة الدراسية أثراً على خيارات الطلاب والطالبات التعليمية تبعاً للوضع الاقتصادي. |
87% من المبحوثين/ات يرون أن لتكلفة الساعة الدراسية أثراً على خيارات الطلاب والطالبات التعليمية تبعاً للوضع الاقتصادي. |
تؤثر تكلفة الساعة الدراسية على خيارات الطلاب والطالبات التعليمية تبعاً للوضع الاقتصادي. |
| 57% من المبحوثين/ات يرون أن اعتماد سياسة خصخصة السلع والخدمات داخل الجامعة هو تمييز ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود. في حين يرى/ترى 11.6% أن سياسة الخصخصة لا تعمل على التمييز ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود. |
54% من المبحوثين/ات يرون أن اعتماد سياسة خصخصة السلع والخدمات داخل الجامعة هو تمييز ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود. في حين يرى/ترى 12.6% أن سياسة الخصخصة لا تعمل على التمييز ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود. |
اعتماد سياسة خصخصة السلع والخدمات داخل الجامعة هو تمييز ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود. |
| عند سؤال المبحوثين والمبحوثات في جامعة بوليتكنيك فلسطين حول ما إذا كان هنالك ممارسات تمييزية ضد الطالبات يتخللها ابتزاز أو تحرش أو اعتداء، أفاد/ت 25% من المبحوثين/ات بأن هذا يحصل في الجامعة. في المقابل، أجاب 39% بلا. |
عند سؤال المبحوثين والمبحوثات في جامعة النجاح حول ما إذا كانت هنالك ممارسات تمييزية ضد الطالبات يتخللها ابتزاز أو تحرش أو اعتداء، أفاد/ت 28.5% من المبحوثين/ات بأن هذا يحصل في الجامعة. في المقابل، أجاب 25% بلا. ومن الجدير بالذكر أن 32% من المبحوثين/ات عبروا/ن أنهم/ن يتخذون الحياد تجاه العبارة كموقف. |
هنالك ممارسات تمييزية ضد الطالبات في تلقي الخدمات التعليمية (ابتزاز، تحرش، اعتداء...). |
| حوالي 60% من أفراد العينة في جامعة بوليتكنيك فلسطين يرون أن الطالبات في الجامعة لديهن القدرة في الحصول على المنح والتغطية المالية (64% من الذكور، و56% من الإناث)، في حين 14% من إجمالي المبحوثين/ات يرون عكس ذلك (9% من الذكور، و19% من الإناث). |
نصف العينة من جامعة النجاح يرون أن الطالبات في الجامعة لديهن القدرة في الحصول على المنح والتغطية المالية (56% من الذكور، و45% من الإناث)، في حين 21% من إجمالي المبحوثين/ات يرون عكس ذلك. |
لدى الطالبات القدرة في الحصول على المنح والتغطية المالية داخل الجامعة وبخاصة الطالبات من الفئات ذات الدخل المحدود. |
| 69% من المبحوثين/ات يرون أن بعض الطالبات يحرمن من الوصول إلى المرافق التعليمية نظراً لعدم توفر القدرة المادية. |
77% من المبحوثين/ات يرون أن بعض الطالبات يحرمن من الوصول إلى المرافق التعليمية نظراً لعدم توفر القدرة المادية. |
تحرم بعض الطالبات في الجامعة من الوصول إلى المرافق التعليمية نظراً لعدم توفر القدرة المادية في الوصول إلى الجامعة. |
أبرز الاستنتاجات
- حوالي ربع المبحوثات في العينة في كل من جامعة النجاح (25%)، وحوالي (28%) من المبحوثات في جامعة بوليتكنيك فلسطين يرون أنه لا تتوفر في الجامعة المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة.
- أكثر من ثلثي العينة (69.3% في جامعة النجاح، و63.2% في جامعة بوليتكنيك فلسطين) يرون أن مشاركة الطالبات في الحياة العامة تساهم في توفير بيئة أفضل للطلاب والطالبات من حيث الوصول والحصول على الخدمات. إلا أنه، وعلى صعيد بوليتكنيك فلسطين، فإن 19% من الطلبة الذكور في العينة لا يرون أن المشاركة تساهم في توفير بيئة أفضل. وعند السؤال حول ما إذا كان ذلك يساهم في توفير بيئة ديمقراطية لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة، عبر 19% من الذكور في كلتا الجامعتين أن ذلك لا يساهم في توفير بيئة ديمقراطية. وعلى صعيد جامعة بوليتكنيك فلسطين، من اللافت للانتباه أن 22.5% من الطلبة والطالبات فضلوا اتخاذ الحياد كموقف تجاه هذه العبارة.
- عند السؤال حول ما إذا كانت مشاركة الطالبات في الحياة العامة في المجمل تأتي بناءً على الانتماء الحزبي، جاءت النسبة ما بين 27% إلى 30% (الأعلى لجامعة بوليتكنيك فلسطين) من المبحوثين والمبحوثات في كلتا الجامعتين بأن المشاركة فعلاً تأتي بناءً على الانتماء الحزبي، في حين عبر/ت 42.6% منهم/ن أنهم/ن لا يؤيدون هذه العبارة في المؤشر (39% من الذكور، و46% من الإناث) في جامعة النجاح، و37.6% لا يؤيدون العبارة في جامعة بوليتكنك فلسطين، ويرون أن المشاركة لا تأتي بناءً على الانتماء الحزبي، دون وجود اختلافات تذكر على صعيد متغير الجنس.
- بخصوص مشاركة الطالبات في الحياة العامة، في المجمل، تعتمد على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية العائلية والعشائرية، عبرت 28% من الإناث أن مشاركة الطالبات تعتمد على الثقافة المجتمعية ذات المرجعية العائلية والعشائرية في جامعة النجاح. وفي جامعة بوليتكنك فلسطين، عبرت 26% من الإناث ضمن العينة أنها تعتمد على المرجعية العائلية والعشائرية.
- ترتفع النسبة عند الحديث عن الوعي والشخصية القيادية وعلاقتها بمشاركة الطالبات في الحياة العامة، حيث عبر/ت 80% من المبحوثين/ات في جامعة النجاح، أنهم يتفقون مع هذه العبارة في المؤشر دون وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. وفي جامعة بوليتكنك فلسطين، عبر/ات حوالي 77.5% من المبحوثين/ات أنهم/ن يتفقون مع هذه العبارة، مع وجود علاقة ذات دلالة إحصائية (73% من الذكور، و82% من الإناث).
- في حين كانت 40% من العينة في جامعة النجاح ترى أن المرجعية الدينية تؤثر على مشاركة الطالبات في الحياة العامة، كانت النسبة أعلى بحوالي 20 درجة؛ إذ وصلت تقريباً 59.7% من المبحوثين/ات في جامعة بوليتكنك فلسطين، 15%، فقط، يرون أن لا علاقة لذلك. ومن اللافت للانتباه أن 19% عبروا/ن بالحياد كموقف تجاه هذه العبارة.
- نصف العينة فقط في جامعة النجاح (50.5%) من الطلاب والطالبات يرون أن الجامعة توفر المساحة اللازمة للطالبات للمشاركة في الحياة العامة (56% من الذكور، و46% من الإناث)، و39% من العينة، فقط، في جامعة بوليتكنك فلسطين، ترى أنه تتوفر في الجامعة بيئة ديمقراطية داعمة لمشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة (48% من الذكور، و30% من الإناث).
- عند سؤال المبحوثين/ات حول موقفهم من مشاركة الطالبات في انتخابات مجلس الطلبة، وما إذا كانت تؤثر على نسب التصويت للقوائم، أفاد/ت 69% من المبحوثين/ات في جامعة النجاح، أنهم يرون أن مشاركة الطالبات، فعلاً، تؤثر في نتيجة الانتخابات، لكن من اللافت للانتباه أن الذكور يرون ذلك بنسبة أعلى من الإناث (75% من الذكور، و63% من الإناث). وعلى صعيد جامعة بوليتكنك فلسطين أجاب/ت حوالي 72% من المبحوثين/ات أنهم/ن يرون أن مشاركة الطالبات تؤثر في نتائج انتخابات مجالس الطلبة فعلاً (79% من الذكور، و64% من الإناث). هذه المؤشرات تشير إلى أن الإناث، وهن صاحبات الشأن فيما يتعلق بالمشاركة للطالبات، يلمسن التأثير على نسب التصويت داخل الجامعات، وهي مسألة تحتاج إلى توسع بشكل كيفي لفهم ذلك.
- عند سؤال المبحوثين/ات حول الموقف من الخطاب العام في مجتمع جامعة النجاح، وما إذا كان داعماً لمشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية، عبر/ت ما يقارب 40% من المبحوثين/ات أن الخطاب العام داعم لذلك، دون وجود فروقات ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس، في حين أفاد/ت ما نسبته 24.5% أن الخطاب العام غير داعم لذلك، دون فروق ذات دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس. وحوالي ربع المبحوثين/ات أفادوا بأنهم يتخذون الحياد في أخذ موقف من هذه العبارة. أما على صعيد جامعة بوليتكنك فلسطين، فقد عبر/ت المبحوثون/ات بنسبة 42.42% أن الخطاب العام في مجتمع الجامعة يدعم مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية (48% من الذكور، و37% من الإناث)، في حين يرى/ترى 22% أن مجتمع الجامعة ليس بداعم (16% من الذكور، و28% من الإناث)، وحوالي 22.5% من المبحوثين/ات أفادوا برغبتهم/ن في التعبير بالحياد تجاه اتخاذ موقف من هذه العبارة. نلاحظ أن النسب تقترب بين الجامعتين في هذه القضية، ومن المهم الإشارة إلى اتخاذ الحياد كموقف في هذه العبارة، ما يعني أن أكثر من خمس العينة لا يرغبون في التعبير تجاه القضايا.
- حوالي 30% في كل من الجامعتين عبرت فيها العينة أنهم يرون أن الثقافة المجتمعية داخل الجامعة تميز ضد مشاركة الطالبات في داخل مجالس الطلبة والأندية الطلابية. لكن من الملفت للانتباه أنه وفيما يتعلق بالطلبة والطالبات في جامعة النجاح، كانوا قد عبروا بالحياد تجاه هذه العبارة، ووصلت نسبتهم حوالي 24%، نلاحظ أن 19% من هؤلاء هم من الذكور و30% من الإناث، وهو فرق ذو دلالة إحصائية لا بد من الإشارة إليه.
- نلاحظ أنه وعند السؤال حول الموقف الطلابي السائد في الجامعة، وما إذا كان لا يثق بقدرة الطالبات على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية، تبين أن 51% من الإناث في جامعة النجاح يرين أن الموقف الطلابي السائد لا يثق بقدرتهن. وفي جامعة بوليتكنيك فلسطين أفاد 40.7% من المبحوثين/ات بأن الموقف الطلابي السائد في الجامعة لا يثق بقدرة الطالبات على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية، دون وجود أي اختلاف ذي دلالة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس.
- ربع الطلبة من عينة جامعة النجاح يرون أن ضعف الشخصية لدى الطالبات هو ما يدفعهن إلى عدم استلام مناصب قيادية داخل مجالس الطلبة وأندية الكليات، وكانت النسبة في جامعة بوليتكنك فلسطين حوالي 34% من إجمالي العينة، مع وجود علاقة ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بمتغير الجنس (40% من الذكور، و29% من الإناث).
- من أبرز الاستنتاجات أن 37.7% من الطلبة والطالبات في جامعة بوليتكنك فلسطين، يرون أن تصنيف مكان السكن (مدينة، قرية، مخيم، تجمع بدوي...) يشكل عاملاً تمييزياً ضد الطالبات في المشاركة في الحياة السياسية داخل الجامعة، مع الإشارة إلى أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بخصوص متغير الجنس (43% من الذكور، و32% من الإناث).
- حوالي 75% في كلتا الجامعتين تتفق على أن وصول الطالبات إلى مراكز قيادية داخل مجالس الطلبة والأندية يعود إلى قوة الشخصية للطالبات.
- 92% من الإناث ضمن عينة جامعة النجاح أفدن بأنهن مع رفع نسبة مشاركة الطالبات في الحياة العامة، في حين عبر 67% من الذكور بذلك. أما على صعيد جامعة بوليتكنك فلسطين، فكانت النسبة 58% من الذكور، و78% من الإناث مع رفع النسبة.
- 78.7% من الطلبة والطالبات ضمن عينة جامعة النجاح يقدمون الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة، ضمن حيزهم/ن الخاص (70% من الذكور في العينة، و87% من الإناث في العينة). أما على صعيد جامعة بوليتكنك فلسطين، فقد أفاد 73% من الطلبة والطالبات بالموافقة على أنهم/ن يقدمون الدعم المعنوي والمعرفي اللازم لتشجيع الطالبات على المشاركة في الحياة العامة ضمن حيزهم/ن الخاص (64% من الذكور، و83% من الإناث).
- 40% فقط من عينة طلبة جامعة النجاح ترى أن الجامعة تقوم بتوفير خدمات صحية مناسبة موائمة لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات، وتساوت النسبة تقريباً مع الذين يرون أن الجامعة تقوم بتوفير ذلك. في حين 31% فقط من إجمالي عينة جامعة بوليتكنك فلسطين ترى ذلك.
- 77% من المبحوثين/ات في جامعة النجاح يرون أن بعض الطالبات يحرمن من الوصول إلى المرافق التعليمية نظراً لعدم توفر القدرة المادية، في حين 69% من المبحوثين/ات يرون أن بعض الطالبات يحرمن من الوصول إلى المرافق التعليمية نظراً لعدم توفر القدرة المادية. تعكس هذه النسب أن العائق المادي أساس في عدم وصول الطالبات إلى الجامعات، وهو ما يعني أنه ما زالت هنالك حقوق أخرى كالحق في الوصول يجب العمل عليها، وتذليل العقبات أمامها، حتى لو كانت اقتصادية.
- حوالي 87% من المبحوثين/ات في الجامعتين يرون أن لتكلفة الساعة الدراسية أثراً على خيارات الطلاب والطالبات التعليمية تبعاً للوضع الاقتصادي.
- عند سؤال المبحوثين والمبحوثات في جامعة النجاح حول ما إذا كانت هنالك ممارسات تمييزية ضد الطالبات يتخللها ابتزاز أو تحرش أو اعتداء، أفاد/ت 28.5% من المبحوثين/ات بأن هذا يحصل في الجامعة. في المقابل، أجاب 25% بـ لا. ومن الجدير بالذكر أن 32% من المبحوثين/ات عبروا/ن أنهم/ن يتخذون الحياد تجاه العبارة كموقف. وعلى صعيد جامعة بوليتكنك فلسطين، أفاد/ت 25% من المبحوثين/ات بأن هذا يحصل في الجامعة. في المقابل، أجاب 39% بـ لا.
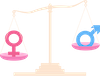 منصة قياس مؤشر التمييز داخل الجامعات الفلسطينية
منصة قياس مؤشر التمييز داخل الجامعات الفلسطينية